الصورة الشعرية في قصائد إحياء النموذج وسؤال الذات – تكسير البنية وتجديد الرؤيا
الصورة الشعرية هي صياغة لغوية أساسها خلق علاقات جديدة وغير مألوفة بين الكلمات في سياق بياني خاص، يفرز دلالات تعبر عن تجربة المبدع وحالته النفسية وموقفه الفكري. إنها تعبير لغوي يتوخی ربط علاقة بين المعنى الحقيقي للألفاظ ومعناها المجازي، ويكون هذا المعنى الأخير هو المقصود.
مكونات الصورة الشعرية
تكون مكوّنات الصورة الشعرية إما قديمة تقليدية كـ: التشبيه، والاستعارة، والمجاز المُرسل، والكناية، أو جديدة مستحدثة مثل: الرمز، والأسطورة. وفيما يلي تعريف لهذه المكوّنات، وأمثلتها:
1 – التشبيه:
التشبيه لغة هو تمثيل طرف بطرف آخر، أي مقارنته به. واصطلاحا هو صورة تقوم على إلحاق شيء بشيء آخر، لاشتراكهما في صفة أو أكثر.
| قال شوقي: أخا الدنيا أرى دنياك أفعی *** تبدل كل آونة إهابا |
2 – الاستعارة:
الاستعارة هي تشبیه حذف أحد طرفيه، واحتفظ فيه بقرينة دالة على المحذوف، وتكون العلاقة بين الطرفين هي: “المشابهة”.
| قال الشابي: وأسير في دنيا المشاعر حالما *** غردا وتلك سعادة الشعراء |
3 – الـمجاز الـمرسل:
كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة أخرى غير “المشابهة”، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وبعبارة أخرى: هو ما ناب فيه المعنى البعيد عن المعنى القريب بحيث لا یجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي. ومن علاقاته:
- السببية
- المسببية
- المحلية
- الحالية
- اعتبار ما كان
- اعتبار ما سيكون
- الكلية
- الجزئية
| – السببية: رعت الماشية الغيث (العشب) – المسببية: قال تعالى: «وَينزّل لكم من السماء رزقا» (العشب) – المحلية: قال تعالى: «واسأل القرية التي كنا فيها» (أهل القرية) – الحالية: قال تعالى: «إنّ الأبرار لفي نعيم» (حالة من السعادة) – اعتبار ما كان: يرتدي الأطفال القطن (الملابس) – اعتبار ما سيكون: قال تعالى: «إنّي أراني أعصر خمرا » (عِنباً) – الكلية: قال تعالى: « يجعلون أصابعهم في آذانهم» (أطراف أصابعهم) – الجزئية: ألقى الإمام كلمة كان لها أثر بالغ في النفوس (خُطبة) |
4 – الكـناية:
وهي أنْ يذكر الشاعر لفظا وهو يقصد غيره، مع جواز حمل معناه القريب والبعيد على وجه الحقيقة. إنها بعبارة أخرى: لفظ يطلق ويراد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي.
| قالت الخنساء: طويل الجاد رفيع العماد *** كثير الرماد إذا ما شتا |
5 – الرمـز:
كلّ كلمة أو عبارة تجردت من دلالتها المعجمية البسيطة، وشُحِنت بدلالة جديدة أقوي تعبيرا وأكثر إيحاء. وهذه الدلالة الجديدة تستفاد من السياق الذي تتواجد فيه تلك الكلمة أو العبارة، وكذا من سياق النص ككل، ومن مقصدية صاحبه. واستعمال الرمز في القصيدة يحتم على الشاعر عدّة أمور لابد من مراعاتها منها:
- خلق السياق الخاص الذي يناسب الرمز لأنه إذا استخدمه منفصلا عن السياق دخل باب “الإبهام”.
- اختيار الألفاظ بعناية بالغة بحيث تكون لها ظلال وإيحاءات كثيرة، لتعبر عن الأحوال النفسية للأديب.
- امتلاك ثقافة واسعة متعددة المشارب.
- الاعتماد على المرجع الثقافي المشترك بينه وبين القارئ الذي يجب أن يتسلح، هو الآخر، بثقافة رحبة تمكنه من التعامل مع الرموز، وبخاصة الأسطورية منها.
- والرمز يتنوع بحسب المصادر أو المجالات التي يستقی منها. ومن هذه المصادر أو المجالات: (الطبيعة، التاریخ، الدين، الحضارة، الأسطورة، الفن…).
| قال البياتي: بابل لم تُبْعث ولم يظهر على أسوارها المبشّر الإنسان ولم يدمرها، ولم يغسل خطايا أهلها الطوفان ولم يقم من قبره عبر الفرات سارق النيران. ◄ فهذا المقطع يتضمن رموزا تنتمي إلى مجالات معرفية متنوعة: – بابل: رمز تاریخي استمده الشاعر من حضارة قديمة في بلاد الرافدين للدلالة على العراق حاليا. – المبشر الإنسان: رمز ديني يحيل على المسيح عليه السلام، وقد وظفه الشاعر للدلالة على البعث والخلاص. – الطوفان: رمز طبيعي يعبر الشاعر من خلاله عن القدرة التي تُطَهّر البلاد من الظلم والفساد، ويمكن أن يكون رمزا دينيا إذا كان الشاعر يستحضر من خلاله طوفان نوح عليه السلام. – سارق النار: رمز أسطوري يدل على الفداء والتضحية والخلاص، إذ يستحضر الشاعر من خلاله “بروميثيوس” الذي سرق النار الحكمة من الآلهة في السماء وأهداها إلى البشر في الأرض لتكون خلاصهم وسعادتهم. |
6 – الأسطورة:
حكاية تقليدية، تلعب فيها الكائنات الخارقة الأدوار الرئيسية، وتروي أحداثا خرافية أو خارجة عن المألوف في سياقات حكائية تمتزج فيها ظواهر الطبيعة بالتاريخ، والعلم بالخيال، والحلم بالواقع. والأسطورة في الشعر تعبير رمزي يستمده الشاعر من الحكايات الطريفة المتوارثة منذ أقدم العهود الإنسانية الحافلة بضروب من الخوارق والمعجزات، وبهذا يجد فيها الشاعر مجالا أرحب للخيال، ومادة خصبة للتعبير ووعاء يتسع لاستيعاب أعمق المشاعر والمواقف والأفكار.
| قال أدونيس: لم يزل شهریار حاملا سيفه للحصاد حاضنا جرة الرياح وقارورة الرماد نسيت شهرزاد أن تضيء الدروب الخفية في مدار العروق نسيت أن تضيء الشقوق بين وجه الضحية وخطی شهریار ◄ لعلّكم تلاحظون أن الشاعر يستحضر أسطورة شهرزاد وشهريار، ولكنه لا يلتزم بها كما هي، بل يتصرف في مضمونها، وإن احتفظ بشخوصها. فشهریار لا يزال مستمرا في التقتيل، لأن شهرزاد لم تقم بدورها في تعديل سلوكه. |
هكذا تشكل الأسطورة أحد المكونات الأساس في البناء الفني والفكري للقصيدة الحديثة، ونمطا من أنماط التعبير الجمالي فيها ورغم تعدد وصعوبة ضبطها، فإن هناك اتفاقا على كونها تمثل طفولة العقل البشري.
طبيعة الصور الشعرية في قصائد إحياء النموذج
اعتماد صور شعرية مستمدة من المحفوظ الشعري:
- صور تتردد في النص بنسبة قليلة.
- صور مفردة، جزئية، بسيطة.
- بدلالات تراثية أغراضية، واضحة ومفهومة.
- بمكونات بلاغية تقليدية (تشبيه، استعارة، مجاز، كناية).
- بعلاقات، بين طرفي الصورة، تقوم أساسا على: (المشابهة، والمجاورة، والقرب).
- بمرجعيات موضوعية محسوسة في الغالب.
- بوظائف توجيهية أخلاقية تربوية، أو تزيينية زخرفية تأثيثية…
الصور الشعرية عند شعراء سؤال الذات
توظيف صور شعرية مستمدة من صميم تجربة صاحبها:
- صور بنسبة كبيرة في النص في النص أحيانا.
- صور قد تتنوع بين: (المفردة، والمركبة، والكلية).
- بدلالات عاطفية وجدانية، وتأملية فلسفية، محورها (الذات) و (الطبيعة).
- بمكونات بلاغية تقليدية أيضا.
- بعلاقات تتأسس علي: (المشابهة، والمجاورة، والتجسيد، والتجريد والتشخيص، والقرب، والتوسط).
- بمرجعيات ذاتية ومحسوسة ومجردة.
- بوظائف تعبيرية/ انفعالية / تأثيرية.
الصورة الشعرية في قصائد تكسير البنية و تجديد الرؤيا
استخدام صور شعرية بطوابع التحديث والمعاصرة:
- صور بنسبة كبيرة ومكثفة في النص.
- صور متنوعة: (جزئية ومركبة، وكلية).
- بدلالات ذاتية وواقعية وإنسانية.
- بمكونات بلاغية تخييلية جديدة (كالرمز والأسطورة)، أو بمكونات تقليدية لكن متصرف فيها.
- بعلاقات تتأسس علي: (المشابهة، والمجاورة والتجسيد، والتجريد والتشخيص، والتوسط، والبُعد، واللاعلاقة).
- بمرجعيات ذاتية واقعية إنسانية محسوسة ومجردة.
- بوظائف جمالية تعبيرية تأثيرية رمزية إيحائية…

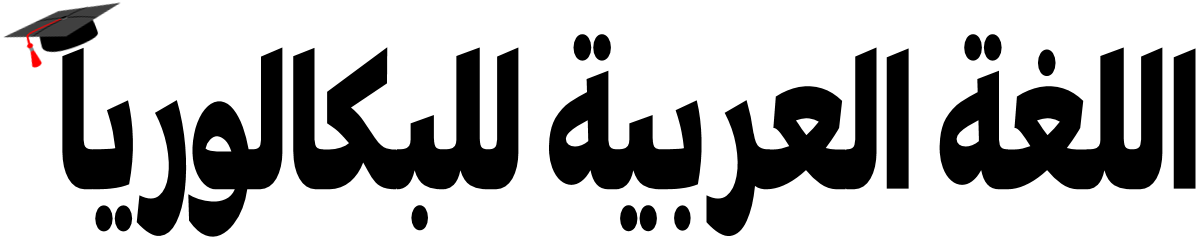




I need to to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed
every little biit of it. I have you book marked to check
out new things you post…
استاد يعلم اجيال